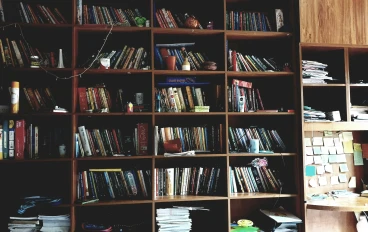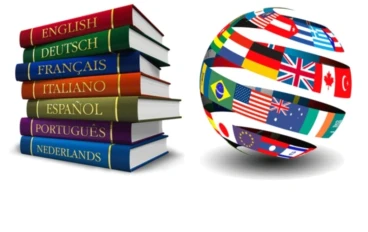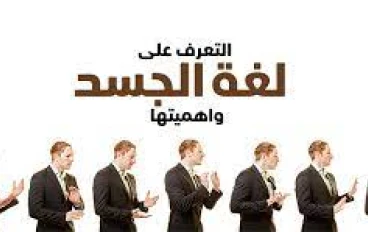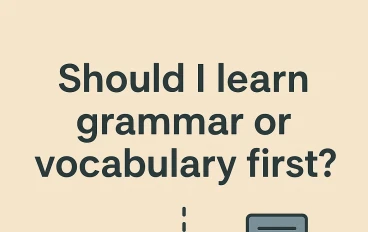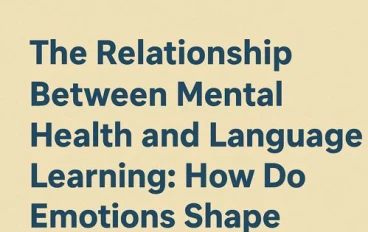التنوين في اللغة العربية
التنوين في اللغة العربية
لقد قيل أن الحقيقة بنت البحث. وربما تم للباحث الصابر الذي لم يحد عن النهجح العلمي القويم غرضه، غير أنه مفتقر إلى الوسائل والأدوات في بعض الأحايين. والوسائل والأدوات في العربية هي مادة الكلام ووسائل التعبير وطرائق الاستعمال، ولم تتيسر هذه الباحث في لغة العرب على نحو ما تتيسر له في اللغات الأخرى؛ ذلك أن الكثير لم يصل إلينا، وهو إن وصل افتقر إلى الصفة العلمية التاريخية؛ فقد جاء في الصاحبي لابن فارس " باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها وإن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير وإن كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أهله".
ويسمى التنوين الذي يلحق الاسم المعرب صرفاً، والاسم المنون مصروفاً أو منصرفاً. وهذا التنوين يعده النحاة دليلا على تمكن الاسم في الاسمية تمام التمكن.
نقول إن النون من الأصوات السهلة التي اطمأنت العربية إلى السكوت عليها والانقطاع عن الصوت عندها.
وربما لمح إلى هذا بعض المحدثين بقوله:" إن التنوين قطع للمدّ الممثل بالحركات".
وربما حركت نون التنوين بحركة لمناسبة اقتضت ذلك كالتقاء الساكنين كما قرئ في قوله تعالى:" إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين". فقد حركت نون (عيون) بالكسر. ويرى الدكتور إبراهيم أنيس" أن الذي يعين تلك الحركة هو طبيعة الصوت وإيثاره لحركة معينة أو انسجام تلك الحركة مع ما يجاورها من حركات".
ويقول الأستاذ إبراهيم مصطفى: " ومعنى التنوين غير خفي؛ فهو علامة التنكير. وقد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم، وهي " ال"، وجعلت للتنكير علامة تلحقه، وهي التنوين".
وإطلاق القول على هذه الصورة جائر على الحقيقة العلمية التاريخية، ذلك أن الأستاذ مصطفى يفترض أن هذا المنهج النحوي هو الوجه الذي اتفقت عليه العرب، ومعنى هذا أنه لم يكن في كلام العرب ما يشير إلى مراحل أسبق من هذا اللون الذي لا يدل على مستوى عال في التأليف، وذلك بعد أن تضلع من العربية وعلومها جماعات وقفوا أنفسهم عليها في عصور متأخرة بالنسبة إلى العربية التي سلخت عنها القرون الطوال.
المنوّن في الكلام هو الغالب في العربية. والصرف هو التنوين. وهذا مذهب المحققين . والأصل في الاسم الصرف. وغير المنون هو القليل المعروف في كتب النحو، والذي حصروه في أبواب معروفة، والاسم غير المنون لا بد أن تتوافر ففيه علتان من تسع أو علة تقوم مقام العلتين، وكل هذا مفصل معروف في كتب النحو، وليست بنا حاجة إلى الرجوع إليه. على أننا لا بد أن نقول أن مسألة العلل المانعة للاسم من الصرف مسألة ينبغي الرجوع إليها بحثا وتحقيقا؛ ذلك أن كثيرا من غير المنون من الأسماء قد اختلف فيه، وربما كان الاسم منونا عند بعضهم وغير منون عند فريق آخر.
فمن العلل المانعة للصرف عندهم الألف المقصورة للتأنيث وهي علة تقوم مقام علتين، وطالب النحو يطمئن إلى هذا ويجريه مجرى القواعد المقررة، غير أن البباحث في مظام النحو المطولة يجد شيئا غير هذا فقد جاء في الكتاب: " وأنهم فرقوا بين الألف التي تكون بدلا من الحرف الذي هو من نفس الكلمة، والألف التي تلحق ما كان من بنات الثلاث ببنات الأربعة، وبين هذه الألف التي تجيء للتأنيث. فأما (ذفرى) فقد اختلف العرف فيها فقالوا: ذفرى أسيلة فنونوا، وهي أقلهما، وقالوا ذفرى أسيلة وكذلك (تترى) فيها لغتان".
والألف والنون الزائدتان في الوصف علة مانعة لصرف الاسم إن كان مؤنث على (فعلى). ذكر الرضى في شرحه على الكافية:" والمطلوب منه انتفاء التاء لأن كل ما يجيء منه (فعلى) لا يجيء منه فعلانة في لغتهم، إلا عند بني أسد فإنهم يقولون في كل (فعلان) جاء منه (فعلى) (فعلانة) أيضا كغضبانة وسكرانة فيصرفون اذن (فعلان).
وقد ذكر النحويون أن التنوين لا يراعي في مواضع معروفة وذلك لالتقاء الساكنين مثلاً، وأن هذا الحذف كثير في كلام العرب. وأنهم مثلاً أبعدوا التنوين عن كل اسم غالب وصف بابن ثم أضيف إلى اسم غالب أو كنية أو أم وذلك نحو قولك هذا (زيد بن عمرو) وإنما حذفوا التنوين من هذا النحو إذا التقى ساكنان. وذلك قولك (اضرب بن زيد) وأنت تريد الخفيفة وقولهم (لد الصلاة) في (لدن) وإذا اضطر الشاعر في الأول أجراه على القياس : ]لوافر[:
هي ابنتكم وأختكم زعمتم *** لثعلبة بن نوفل بن جسر
وفي كتاب سيبويه باب ما يحرك فيه التنوين في الأسماء ويمثل له بقولهم: (هذا زيد بن أخيك) و(هذا زيد ابن أخي عمرو) و(هذا زيد الطويل) و(هذا عمرو الظريف). وهذا يدل على أن المسألة لم تستقر على حال، وأن من ألف التنوين آثر لسانه التخفيف ولم ينون اتقاء الساكنين.
ولا بد من كلمة أخيرة في هذا الموضوع، وذلك أن التنوين ربما توهم فيه فظنوه نوناً كما في كلمة " تضامن" إذ الأصل فيها " تضام" بالتنوين من الضم الذي يفيد الجمع. وعلى هذا الأساس نستطيع فهم " صلدم" فالميم فيها من هذه الزيادة أي الغرض " التمييم" مقابلة للتنوين وليست من " صلد" و" صدم" كما ذهب إليه ابن فارس.
وقد أضيف التنوين إلى طائفة من الأدوات لفظاً وخطاً فأضاف إليها معاني جديدة أو قل اختصاصات جديدة، ومنها " ما" الموصولة التي أصبحت " من" وقيدت بالعاقل وإن ورد في فصيح العربية أن الأولى استعملت وأريد بها العاقل كقوله تعالى:" سبح لله".
ومن هذه الأدوات (إذا) التي أفادها التنوين شيئا آخر فصارت (اذاً) أو (اذن).
ومن هذه الأدوات (لا) التي أصبحت مع النون ( لن)، وقيدت بمعنى خاص وهو كونها لنفي المستقبل، ويرى الخليل أن (لن) مركبة من (لا) و" ان".
وربما استطعنا أن نقول أن " لن" و" لم" من حقيقة واحدة ولكن الاستعمال قد خص كلا منهما باستعمال خاص.