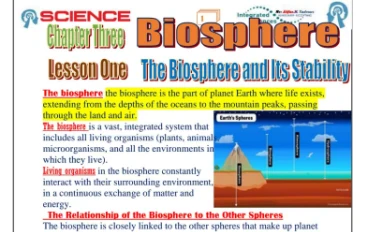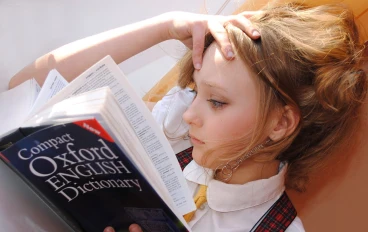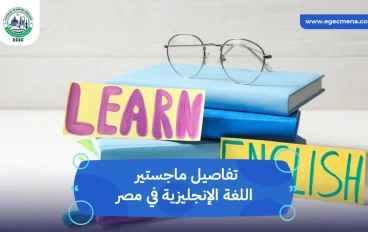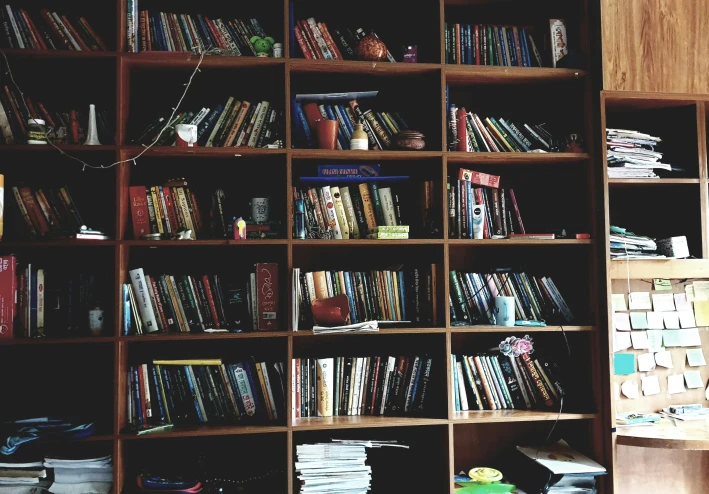
ماذا تعرف عن المشكلة اللغوية ؟
ماذا تعرف عن المشكلة اللغوية ؟
للغة تاريخ نتبين فيه أصل اللغة ونشوءها وتطورها والمراحل التي قطعتها في عمرها الطويل حتى نصل في هذا البحث إلى ما آلت إليه في عصرنا الحاضر، كما أن لسائر العلوم تاريخاً نهتدي فيه للأصول التي قامت عليها تلك العلوم، ولسائر المراحل التي مرت عليها.. والبحث في العربية يؤدي بنا إلى التزام الناحية التاريخية، وإذا قلت: إن اللغة العربية بدع بين اللغات فلا نرانا نعدوا الصواب كثيرا، وذلك أننا لا نعرف تاريخ هذه اللغة في مرراحلها الأولى إذ ليس من المعقول أن هذه اللغة بدأت بهذه النصوص الشعرية الجهلية. فهذه النصوص الجاهلية تقدم للباحث نماذج عالية من العربية، وهذه النماذج لا يمكن أن تكونن بأي حال من الأحوال من البداييات في اللغة، فلا بد أن تكون العربية قد قطععت قبل هذه النصوص مراحل أخرى من تاريخها لم تكن فيها على هذا المستوى العالي من حيث قدرة اللغة على أداء المعاني ومن توفر المادة العربية للتعبير عن النواحي المادية وانصرافها إلى المعنويات من الأمور توسعا ومجازا. ولا نريد أن نخوض في موضوع الصحيح والمنحول من هذه النصوص، فليس ذلك بضائر قيمة النصوص اللغوية، وإنها صورة للحياة الجاهلية، ذلك أن وجود المنحول من هذه النصوص لا يمنع من وجود الصحيح ونسبته إلى قائليه.
ولابد أن نبين أن الآثار الأدبية في العصر الجاهلي شعرية في الغالب، والنثرية منها قليلة جداً، وهي إن وجدت، فلا يصح الاطمئنان إليها. وإلى هذا ذهب الكثيرون من الذين عنوا بتاريخ الأدب الجاهللي. ولا نريد أن نخضع الأمثال القديمة الجهلية للمادة التي لا يطمأن إليها، فالأمثال – على أنها نثرية – لا نستطيع أن نعدها من النثر العالي الذي يقصد إليه الباحثون في تاريخ الأدب، ذلك أنها مادة شعبية تعكس التجارب التي مرت بها المجتمعات القديمة . والأمثال تعرض لأية أمة من الأمم ولا سيما البدائية منها.

على أن الباحث في النصوص الشعرية الجاهلية ونجد فيها من عيوب النظم شيئاً لا يجده في النصوص الشعرية في العهود الإسلامية، وهذه العيوب تتعلق بالحفاظ على الوزن في الشعر.
وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا بالناحية التاريخية. وأعني بذلك أن هذها لنصوص لم تكتمل موسيقاها وأنها مرحلة من مراحل التطور الفني منن حيث المبنى في القصيدة العربية. وأنت ونجد هذا الخروج عن ضوابط الوزن عند سائر الشعراء الجاهليين، فدونك معلقة امرئ القيس لتجد فيها قوله:
إذا قامتا تضوع المسك منهما *** نسييم الصبا جاءت برييا القرنفل
وقوله:
ألا رب يومٍ لك منهن صالح *** ولا سيما يوم بدارة جلجل
وقوله:
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها *** لدى الستر إلا لبسة المتفضل
وقوله:
أصاح ترى برقاً أريك وميضه *** كلمع اليدين في حبيّ مكلل
وقوله:
قعدت له وصحبتي بين ضارج *** وبين العذيب بعد ما متأملي
وأنت ونجد شيئاً من هذه المخالفات في شعر طرفة بن العبد كقوله:
كأن البرين والدماليج علقت *** على عشر أو خروع لم يخضد
وقوله:
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه *** فإن القرين بالمقارن مقتد
ومنه ما جاء في قصيدة زهير ،، كقوله:
رعوا ما رعوا ظمئهم ثم أوردوا *** غماراً تفرى بالسلاح وبالدمِ
وهذه من السمات البارزة في القصيدة الجاهلية، وربما كان منه في شعر المخضرمين من الشعراء. وهو من غير شك دليل على أن القصيدة العربية الجاهلية في طور التكوين من الناحية الفنية وأنها منتقلة من مرحلة إلى أخرى وفي كل مرحلة من هذه المراحل تستفيد شيئاً لاستكمال عناصرها الفنية.
ولم يؤثر عن الجاهليين نصوص نثرية كثيرة كما هي الحال في الشعر،، وسبب ذلك معروف عند الباحثين في تاريخ الأدب الجاهلي، وليس من غرضنا في هذه المقالة أن نعرض لهذا الموضوع. على أنه لا بد أن نقرر أن أمة تتسع لغتها لهذه النصوص الجميلة العالية من الأدب لا بد أن يكون لديها شيء من النثر، ولكن هذه النصوص النثرية التي نفترض وجودها لم تصل إلينا. إذا فالباحث في النثر العربي مضطر أن يبتدئ بالقرآن الكريم ويعد نصوص القرآن بداية هذا اللون الأدبي من الناحية الواقعية، وهو مضطر أيضاً أن يفترض أن النثر العربي لا بد أن يكون قد مر بمراحل تاريخية.
ولغة القرآن وأسلوبه يطلعان الباحث على مستوى رفيع من حيث المبنى وغزارة المادة اللغوية، ومن حيث قدرة هذه القوالب اللفظية على الإعراب عن دقائق المعنى، وخواطر الفكر، ولعل هذا كان السر الذي حدا بالباحثين إلى القول بالإعجاز في القرآن .
والبحث في تاريخ القرآن يدلنا على أن لغة القرآن قد طبعت العربية بطابع واضح مبين وقضت بذلك على آثار اللهجات الإقليمية، وأطلعت على المجتمع العربي الإسلامي الأول على نموذج عالٍ لهذه اللغة، فأخذوا بها. وفي القرآن ينكشف الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد لأول مرة في تاريخ اللغة العربية، بحيث لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا نموذجاً ضعيفاً له، من حيث ظاهر وسائل الأسلوب، ومسالك المجاز والدلالة. وإلى مثل هذه ذهب المستشرق الفرنسي الكبير "ريجيس بلاشير" في محاضرة له، فهو يقول: ومنذ ظهر الإسلام لم تعد اللغة العربية آلة عادية للكلام والتخاطب، بل لن نستطيع لها فهماً إن نحن أهملنا أهمية هذا "الحدث القرآني" هذا الحدث الذي بفضله تجاوزت اللغة حدود الإنسانية المحضة.
والبحث في تاريخ العربية يدلنا على الجهود التي بذلت كي تسود لغة التنزيل في وضوحها والتزامها الإعراب، ولنكون لغة عامة يعرفها كل العرف لا أثر فيها للغات الخاصة التي اعتاد كل طائفة منهم استعمالها والقراءة بها، فقد ورد أن عمر بن الخطاب قد سمع رجلا يقرأ (عتى حين) في قوله تعالى: (ليسجننه حتى حين)، فقال من اقرأك ؟ قال، ابن مسعود، فكتب إليه: إن الله أنزل هذا القرآن عربياً، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل.
وما استطاعت لغة القرآن والحديث أن تأتي على اللهجات الدارجة المحلية، أو قل على العربية المستعملة السهلة، والتي تخفف من قيود الضوابط الإعرابية الثقيلة. ومن هنا فالعربية شفعية التعبير منذ أن كانت، ذلك بأن فيها لغة فصيحة يتوخاها الكاتب في كتابته، وهي ملتزمة بضوابط الإعراب، ولغة أخرى يقولها الناس، ويستعملونها دون أن يلزموا أنفسهم بعناء هذه الضوابط، وربما تعدى الأمر مسألة الإععراب إلى الألفاظ نفسها، فقد يكون في ألفاظ الثانية ما هو بعيد عن العربية، وأنه قد دخل فيها نتيجة اتصال العرب أنفسهم بغيرهم من الأقوام، والاتصال حاصل في كل عصر، فقد تهيأ للعرب في أطراف شبه الجزيرة العربية أن يتاخموا أقواماً غيرهم، فلم تسلم بذلك سليقتهم. ومن أجل ذلك حرص عمر على الأخذ بقراءة تعتمد على لغة قريش، وإلى مثل هذا كان يرمي عثمان بن عفان من جمعه القرآن ليكون المسلمون مجتمعين على قراءة واحدة فنبذوا ما كان عندهم مما هو مغاير لما اتفق عليه.
ولا يعدم الباحث أن يجد في كتب التفسير والقراءات وكتب الغريب وكتب النحو من هذا الباب شيئاً كثيرا من القراءات. ومرد ذلك أن الناس قد اعتادوا على أساليب في التعبير خاصة بهم، وبذلك قرأوا. وإن طائفة كبيرة من هذه القراءات الخاصة قد اعتبرت من شواذ القراءات. ونتبين من البحث في لغة القرآن أن هذا الحدث القرآني العظيم قد عمل على توحيد العربية وطبعها بطابع خاص فيه الشمول وفيه العموم بحيث تيسر لهذه اللغة أن تكون لغة العرب عامة وأنها تغلبت على الكثير من معالم اللهجات السائرة.
ووجود اللهجات السائرة وتنصلها عن التمسك بقيود الإعراب دليل على ظهور مرحلة جديدة في تاريخ العربية أوشكت أن تعم لولا ما كان من أمر لغة التنزيل. وفي هذه المرحلة الجديدة تخففت العربية من ضوابط الإعراب.
على أن المعلومات التي بين أيدينا عن اللهجات الخاصة لا تتعدى الإشارات الموجزة والعلامات التي لا تعدو أن تكون ملاحظات لا تكون في مجموعها مادة كافية لرسم صورة للهجة من اللهجات في بداية القرن الأول الهجري، ذلكك أن النحويين واللغويين قد جمعوا هذه الملاحظات منذ أن بدأوا في تثبيت قواعد العربية، وظلت هذه الملاحظات تتناقل من جيل إلى جيل دون تصنيف وضبط بحيث لا نستطيع أن ننسب على وجه التحديد أية إشارة من هذه الإشارات اللغوية إلى أصحابها، والأمثال كثيرة للبرهنة على ترددهم وعدم تحريهم وجه الصواب في هذه الإشارات بحيث يبدو فيها الباحث أثر الاصطناع والكذب والتقليد فقد جاء في كتب الأدب قول هوير الحارثي:
تزود منا بين أذناه ضربة *** دعته إلى هابي التراب عقيم
وفي البيت التزام المثنى الألف في جميع الأحوال، وهي لغة بني الحارث بن كعب ، وهي عند هؤلاء قلب الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفاً فيقولون: أخذت الدرهمان، واشتريت ثوبان . وفي هذه اللغة أن ألف حرفي الجر (إلى) و(على) تبقى على حالها إذا كان مدخولها ضمير غائب أو مخاطب، كما جاء في النوادر لأبي زيد الأنصاري، إن المفضل الضبي ذكر لبعض أهل اليمن قوله:
أي قلوص راكب تراها *** طارو علاهن فطر علاها
ولم ينسب السيوطي هذه اللغة لبني الحارث بن كعب وحدهم، فقد عزاها لبني العنبر وبني الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان ومزدادة وعذرة.
وهذه الإشارات لا تتجاوز مسائل الإبدال والقلب وسائر الحركات وما يتعلق بشيء قليل من الأمور الصوتية، ولم يعدها بعضهم من المستساغ المقبول، فالسيوطي يحشرها في باب" الرديء المذموم من اللغات" كالكشكشة والكسكسة والتلتلة والعنعنة والفحفحة والعجعجة وغيرها. كما أنها غير منسوبة نسبة صحيحة ، فالعنعنة لغة قيس وتميم عند السيوطي، وهي تعرض في لغة قضاعة عند الثعالبي، وفي لسان العرب غير هذا.